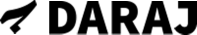في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتدى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، غيلاد إردان (Gilad Erdan) نجمة داوود صفراء على سترته مُخاطباً مجلس الأمن، في مشهدٍ يسترجع تمييز اليهود بالعلامة نفسها في معسكرات الاعتقال النازية التي قضى فيها الملايين منهم.
كُتب على النجمة الصفراء بالإنكليزية never again (لن تتكرر)، في إشارة إلى المحرقة النازية، وفي مساواة ضمنية بين حركة “حماس” والرايخ الألماني في الحرب العالمية الثانية.
ولأن إيران كانت مُتهمةً بتحريك هجوم السابع من تشرين الأول، استكمل الدبلوماسي الإسرائيلي الصورة بتشبيه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بأدولف هتلر، ثم استطرد ليدين، ضمناً، كل من يتحدث عن حقوق أهل غزة في ظل الهجوم الإسرائيلي: “يؤسفني القول إن هذا المجلس لو كان موجوداً، خلال المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، صبيحة السادس من حزيران/ يونيو 1944 لكان مشغولاً بمناقشاتٍ ساخنة عن المُتوافر من الكهرباء والوقود لسكان مدينة ميونيخ الألمانية بينما يستعد الحلفاء للنزول على شواطئ النورماندي”.
عاد إردان الى “حماس”، التي كما قال، لا تريد سوى الحل النهائي نفسه الذي سعى إليه النازيون: إبادة اليهود. المنطق نفسه استخدمه بنيامين نتانياهو مراراً في حديثه عن “حماس” بعد السابع من تشرين الأول، وحينما لم يدعِ تطابق “حماس” والنازية، وصمها بالداعشية (هو وآخرون).
التشبيه بالحرب العالمية الثانية أتى أيضاً في مقابلةٍ مع الدبلوماسي الإسرائيلي المُخَضَرم داني أيالون، سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، ثم نائب وزير خارجيتها سابقاً، يوم الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الماضي على الإذاعة البريطانية (World Service)، إذ قال إن الخيار الوحيد لـ”حماس” هو الاستسلام غير المشروط، وإلا فدم أهل غزة المراق هو جُرم “حماس” المُتهمة، كما سمعنا مراراً، باستخدام المدنيين دروعاً بشرية.
حينما عاود المذيع الإشارة الى مسؤولية إسرائيل عما تلقي من قنابل وقذائف من السماء ومن البر والبحر على القطاع المحاصر، رد أيالون بمنطق زميله نفسه في مجلس الأمن بـأن أحداً لم يكن ليدين قصف المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية، والتي انتهت، كما يجب أن يحدث مع “حماس”، لا فقط بهزيمة الرايخ، لكن بـ”استئصال النازية” denazificatio.
وأخيراً وليس آخراً، حرص رئيس الجمهورية الإسرائيلي، اسحق هرتزوغ، على التلويح للإعلام بترجمة عربية لكتاب أدولف هتلر “كفاحي”، عليها صورة الزعيم النازي، قال إنها وُجدت في مخابئ لـ”حماس”، قائلاً :”هذا هو الكتاب الذي أدى إلى المحرقة والحرب العالمية الثانية”.
إٍسرائيل، التي ليست في وارد الزوال قريباً كما قال مشعل في خطابه هذا، والتي احترفت عبر عقود لعب دور الضحية، يحكمها اليوم يمين ديني يمثل “داعشيةً يهودية”، لا خير في التساوي مع أمثال هؤلاء أو التماهي معهم في المنطق وإن باتجاه معاكس.
كل من ذكرنا يخاطبون جمهوراً غربياً تربى على ذكرى جرائم النازيين وعلى مظلومية اليهود، وهذه الأخيرة يُفتَرض أنها كفيلة بإسكات أي نقد لسبيل الخلاص (المُفترض) مما عاناه اليهود عبر تاريخهم: وطنٌ لهم، إسرائيل، حتى وإن استلزمت حماية الوطن اليهودي هذا اليوم إبادة أهل فلسطين أو طردهم من ديارهم.
لكن تسويق هذا المنطق لم يعد سهلاً كما كان لعقود، فحربُ الذاكرة هذه بما فيها من تذكير وإنساء (أي دفع الى النسيان) لم تعد محسومةً لصالح إسرائيل كما كانت سابقاً، بل على مستوى الشارع في دولٍ غربية كثيرة، بما في ذلك بين يهود، ظاهرٌ أن إسرائيل لم تعد تملك زمام السردية السائدة، بل هي تخسر باطراد، حتى وإن لم يصل تأثير ذلك بعد الى سياسات الحكومات.
الصراع على الذاكرة هذا، على تعقيد آلياته، بسيط في الأساس، علماً أن الذنب في المشهد، من جهة، لا يتحمله طرف واحد، بل كنا نحن أحياناً، عرب ومسلمون، شركاء في الإضرار بقضيتنا، ومن جهة أخرى لعب يهودٌ، بل وإسرائيليون، دوراً أساساً في دحض منطق المشروع الصهيوني.
أشد نقد لارتداء نجمة المحرقة الصفراء في مجلس الأمن، أتى من مدير متحف المحرقة في إٍسرائيل داني دايان، الذي غرد على موقع X: “أحزننا أن نرى أعضاءً من الوفد الإسرائيلي للأمم المتحدة يرتدون النجمة الصفراء. هذا مشين لكلٍ من ضحايا المحرقة ولإسرائيل. النجمة الصفراء ترمز الى عجز الشعب اليهودي وكون اليهود تحت رحمة الآخرين. اليوم نحن نملك دولة مستقلة وجيشاً قوياً. نحن المتحكّمين في مصيرنا. اليوم [يجب أن] نرتدي العلم [الإسرائيلي] الأزرق والأبيض لا النجمة الصفراء”.
ادعاء موقع الضحية الذي عادةً ما تضمنته ذكرى المحرقة، يبدو كنزاً أثمن من أن تضحي به إسرائيل للواقع أو الكرامة كما طالب مدير متحف المحرقة. التاريخ في هذه السردية يبدأ ويتوقف حيث تريد إسرائيل، ومع تغييب التاريخ واستحضاره انتقائياً يُغّيب الواقع أو على الأقل بعضه، ومع ذلك بالضرورة تُعطّل الأحكام الأخلاقية، سواء على ما تفعله إسرائيل عياناً بياناً اليوم (مع الشكر لوسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المجزرة الجارية بثاً حياً متواصلاً)، أو حتى حقائق الأفعال التي تستلهمها هي وأنصارها (مثلاً لا حصراً: ليس صحيحاً أن أحداً في بريطانيا لم يسائل التدمير الكامل للمدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، إذ قرر وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا وقتها؛ تحديداً بعد ضرب مدينة درسدن العنيف في شباط/ فبراير 1945؛ تغيير طبيعة الهجمات الجوية على ألمانيا النازية لتخفيف ضررها قدر المستطاع ).
ولادة المشروع الصهيوني وبداية الهجرة الى فلسطين أواخر القرن التاسع عشر، سبقتا المحرقة النازية بعقود، لكن هذه الأخيرة كانت التأكيد الذي احتاجته الفكرة الصهيونية: لا أمان لليهود إلا في “وطنهم” في فلسطين التاريخية، التي كانت قبل عشرات القرون، حسب الرواية التوراتية، محل دولتهم. لذلك، يتمحور التاريخ حول المحرقة، فلا يكون الجهد موجهاً فقط للتركيز عليها بل ولتهميش ما يسبقها ويلحقها على حد سواء.
اضطهاد اليهود تاريخياً لم يكن يوماً مشكلة في العالم الإسلامي حتى ولادة الصهيونية، بل ثابت أن اليهود فروا من اضطهاد أوروبا الكاثوليكية في القرون الوسطى إلى العالم الإسلامي، مظلومية اليهود التاريخية لم تولد لا في فلسطين ولا في بلد قريب منها. أما بالنسبة الى “العودة” لـ”أرض الأجداد” التي طُردوا منها، فهنا أيضاً يأتي الرد من إسرائيل.
فكرة “العودة” تقوم على أن يهود “الشتات” هم من نسل أولئك الذين طردهم الرومان من فلسطين بعد الثورة اليهودية على حكم روما في القرن الأول الميلادي، ومع ذلك ثمة افتراض بأن “العائدين” كلّهم من نسل النبي يعقوب. لكن قبل عقدين، نشر شلومو ساند، أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب، كتابه المُعنوَن “اختراع الشعب اليهودي” الذي جادل فيه أن الرومان لم يطردوا كل اليهود من فلسطين، بل كان هذا إدعاءً مسيحياً صوّر التهجير من فلسطين عقوبةً لليهود على رفضهم الإيمان بالسيد المسيح. ومع ذلك، حسب الكتاب، جلّ اليهود اليوم هم ممن اعتنقوا اليهودية عبر التاريخ، فلا هم من نسل يعقوب ولا أتى أسلافهم من فلسطين الرومانية، وهو ما يعني حُكماً أيضاً أن يهود القرن الأول هم أسلاف فلسطينيي اليوم، أو على الأقل كثيرٌ منهم.
وبغض النظر عن صحة نظرية ساند من عدمها، الادعاء الصهيوني قائم على إلغاء 19 قرناً من التاريخ، ما بين الطرد الروماني لليهود في القرن الأول الميلادي و”عودتهم” في القرن العشرين. ثم يُهمش تاريخ المسلمين مع اليهود، لصالح المحرقة وما عاناه اليهود الأوروبيون على الجانب الآخر من البحر المتوسط.
ولأن التاريخ في قلب المعركة، ثارت ثائرة إسرائيل على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حين قال في مجلس الأمن ما نعرفه جميعاً: ما حدث يوم السابع من تشرين الأول 2023 لم يأتِ من فراغ. لم يؤيد الرجل لا “حماس” ولا ما قامت به، فقط ذكر السياق، لكن السياق يعني التاريخ القريب الذي يعرفه كل حي، وذلك يستدعي الحساب والتفكير، وسيفكك حتماً دعوى المظلومية الإسرائيلية، لذلك كان من جملة ما اتّهمت به إسرائيل غوتيريس “دعم الإرهاب”، لكن من ربط تهمة الإرهاب بإسرائيل، لا بالفلسطينيين، ولادةً واستمراراً، لم يكونوا إلا إسرائيليين.
وثَّق من يُعرفون بـ”المؤرخين المراجعين” أو “المؤرخين الجدد”، وباستخدام سجلات ما يسمى رسمياً “جيش الدفاع الإسرائيلي” (لاحظ كيف تلغي هذه التسمية، لمن سلم بمعناها، مجرد احتمال الهجوم) لما جرى خلال النكبة قبل 75 عاماً من تطهيرٍ عرقي ممنهج. أسماء المؤرخين والأكاديميين الإسرائيليين ممن شكلوا هذا التوجه، تشمل آفي شلايم، إيلان بابيه وبيني موريس. عنوان كتاب إيلان بابيه الأشهر يخبرنا قصة عام 1948 باختصار: “التطهير العرقي لفلسطين”.
استحضار المحرقة والتركيز على موقع الضحية يستهدفان إشاحة النظر عن كل هذا التاريخ، ولأن المحرقة شر مطلق يُقدم كل ما ومن يمكن اتهامه بمحاولة تكرارها، هو الآخر كشر مطلق لا بد من القضاء عليه، ويُرّحل إلى أجلٍ غير مسمى كل أمرٍ آخر، بما في ذلك استخدام جريمة المحرقة لتبرير جرائم أخرى ضد أبرياء(من ثَم عنوان كتاب نورمان فنكلشتين، الأكاديمي الأميركي – اليهودي، الابن لوالدين ناجيين من المحرقة، المعادي للصهيونية: “صناعة المحرقة”).
هذا التراكم المعرفي الذي أنتجه أكاديميون يهود وإسرائيليون، ركنٌ أساس لما شهدنا من تحركات ضد إسرائيل في شوارع مدنٍ غربية أخيراً، وهو بالغ الأهمية حتى وإن كان تالياً لتأثير الإعلام عبر الإنترنت الذي حرر المعلومات من سيطرة وسائل الإعلام الكبرى، حيث الحضور الصهيوني قوي إن لم يكن طاغياً. لا يبدو إذاً، أن محاولة جوهرة الجانب الفلسطيني كشرٍّ مطلق واجب الإبادة كالنازيين ناجحة، تماماً كما نعرف أن جوهرة الطرف الآخر واختصاره في موقف واحد لا هي بالدقيقة ولا بالحكيمة، فأي خدمة أثمن لمن يرتدي نجمة داوود الصفراء كأنما هو أمام محرقة نازية من طرفٍ فلسطيني يتحدث عن شر “اليهود”؟.
إقرأوا أيضاً:
في خطبة طويلة ألقاها عضو حركة “حماس” البارز وقائدها السابق خالد مشعل عبر الإنترنت يوم 19 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، مخاطباً أعضاء حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية المغربية ، وفي إشارةٍ واضحة الى اليهود كجوهرٍ شرير لا يتغير ولا يتبدل، تحدث عن أولئك الذين “كذبوا على ربهم، كذبوا على البشر”، “هذا عدو مجرم قتل الأنبياء من قبل: تجرأ على الله”، “قالوا يد الله مغلولة” (القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية 64) وقالوا “الله فقير ونحن أغنياء” (القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 181)، “وقتلوا الأنبياء والمرسلين، وعادوا ربهم”.
استطرد مشعل ليذكر أكثر من مرة :”الحلف الصليبي-الصهيوني” (في تعبيرٍ يذكر بتنظيم “القاعدة” الذي عرّف نفسه بالعداء “للصليبيين واليهود”)، وبعدما وصف ما يجري اليوم في غزة بـ”الهولوكوست الحقيقي” (هل ما سبق كان “هولوكوست خيالياً”؟)، قال مناقضاً نفسه: “اليوم في [أي: توجد] حالة يقظة… هناك إعلام حر في الغرب… أصوات مسيحية ويهودية أيقظتهم هذه الجرائم”.
إذا كان هناك “يهود” أيقظتهم هذه الجرائم، فلم جَوهرتهم كأنهم شيء واحد؟ طبيعة كلام مشعل ليست غريبة على “حماس” ولا على أعضائها. ميثاق الحركة التي خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، يلتزم المنطق نفسه مستخدماً نصوصاً من القرآن والسنة مراراً وتكراراً.
قبل أربعة أعوام، دعا فتحي حماد، أحد قيادي “حماس” في قطاع غزة، إلى الهجوم على كل “يهودي موجود في الكرة الأرضية ذبحاً وقتلاً”، آنذاك تبرأت الحركة رسمياً من تصريحاته، لكن لا يبدو أنه كان منفرداً بأفكاره التي أفصح عنها.
لغة ومنطقٍ كهذين، من يخدما؟ أليس هذا هدراً لما قدمه يهودٌ وإسرائيليون من حقائق موثقة تدعم فلسطين وأهلها وتوثق مظلوميتهم هم دون عدوهم الصهيوني؟ أليس المطلوب إثبات استعداد الفلسطيني للتعايش مع كل مختلف يعترف بحقوقه على النقيض من رفض إسرائيل له أم العكس؟ أليست الاختلافات داخل المجتمعات اليهودية بل وداخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، فرصةً لبناء تحالفات ومساحة للمناورة السياسية؟
إٍسرائيل، التي ليست في وارد الزوال قريباً كما قال مشعل في خطابه هذا، والتي احترفت عبر عقود لعب دور الضحية، يحكمها اليوم يمين ديني يمثل “داعشيةً يهودية”، لا خير في التساوي مع أمثال هؤلاء أو التماهي معهم في المنطق وإن باتجاه معاكس.
المأساة أكسبت الفلسطينيين الأرضية الأخلاقية الأعلى، تلك المستحقة للضحية عن حق، مأساة أخرى أن يضيِّع الجمود الفكري وضيق الأفق والقراءات الساذجة للتاريخ والواقع التي تجوهر كل مختلف، هذا المكسب باهظ الثمن (أي صليبية تلك الباقية اليوم في أوروبا العلمانية؟ ألم يقتل الصليبيون اليهود ويضطهدوهم؟).
خلال تظاهراتٍ في مدن مختلفة بالولايات المتحدة، هتف أعضاء منظمة “أصوات يهودية من أجل السلام”: “ليس باسمنا”، في تبرؤ مما ترتكبه إسرائيل من جرائم بصفتها الوطن اليهودي، أي حماقة هي أن يوضع هؤلاء مع نتانياهو في فئة واحدة؟ أي ظلم لفلسطين ثم لهم؟.